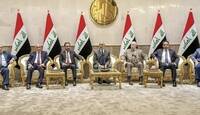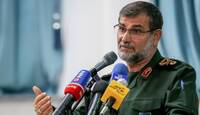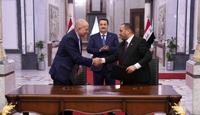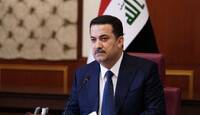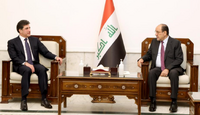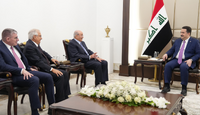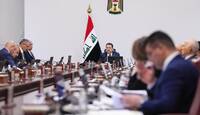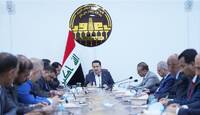بغداد / متابعة سكاي برس
أصبح الإسلام موضوعًا رئيسيًا في النقاش العام والجدال السياسي على مدار العقدين الماضيين.
ومن الجهود التي بذلتها الجماعات الإسلامية مثل جماعة "الإخوان المسلمون" للوصول إلى السلطة من خلال صناديق الاقتراع، إلى الراديكالية العنيفة لـ"الدولة الإسلامية"، كانت الصورة المهيمنة للإسلام في السياسة العالمية تتلخص في الأيديولوجية الدينية التي يتبناها الفاعلون غير الحكوميين الذين يرغبون في رؤية شكل أكثر "إسلامية" للسياسة.
لكن ماذا عن الدول نفسها؟
غالباً ما تبدو النزاعات بين حكومات الشرق الأوسط أنها تدور حول القوة والنفوذ مثل المملكة العربية السعودية التي تقود حرباً في اليمن ضد الحوثيين، والتي تعتبرهم بمثابة شكل من أشكال التوسع الإيراني.
لكن هناك جانب آخر لمعظم صراعات الحكومات الإسلامية، فهم أيضاً يستخدمون الإسلام من أجل غايات سياسية.
في كل بلد تقطنه غالبية مسلمة، يعد الإسلام عملة أيديولوجية مهمة، ووحيدة أحيانا، التي يمكنها أن تختلط بفعالية مع السياسة الواقعية، فمع تراجع الاشتراكية والعروبة في الشرق الأوسط، فإن المنافسة الإيديولوجية الحقيقية الوحيدة للإسلام تأتي من القومية.
لكن القومية، بحكم تعريفها، يصعب تعزيزها خارج الدولة، وهذا يعني أن الحكومات، حتى العلمانية منها والتقدمية، لديها حافز قوي لإدخال الإسلام في سياستها الخارجية، باستخدام الأفكار الدينية لزيادة هيبتها وتعزيز مصالحها في الخارج لنشر، ما نسميه "القوة الإسلامية الناعمة".
ومع الحضور الإلزامي للإسلام في النقاش العام يتحول الدين من مسألة إيمان شخصي إلى مسألة أمن قومي، حيث تشعر الحكومات بأنها مضطرة إلى إشراك نفسها بشكل مباشر في المناقشات حول طبيعة الإسلام وإلا فإنها تخاطر بترك فراغ إيديولوجي يملؤه المنافسون المحليون، وبعبارة أخرى، فإن الخلافات الداخلية حول دور الإسلام وأهميته في السياسة اليومية تشكل الطريقة التي توظف بها الدول الإسلام ضمن سياستها.
ولا يعد استخدام القوة الناعمة الإسلامية أمرا جديدا، ومنذ الستينات، استثمرت المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات لتمويل بناء المساجد، ونشر نصوص دينية (غالباً ما كانت مثيرة للجدل)، وتقديم منح دراسية للدراسة في الجامعات الدينية السعودية.
وكان تصدير النسخة السعودية "المتشددة" من الإسلام مدفوعا بإحساس العائلة المالكة والمؤسسة الدينية بالالتزام بنشر الإسلام، ولكنها خدمت أيضًا غرضًا جيوسياسيا، ما سمح للمملكة العربية السعودية بالتنافس مع المنافسين الإقليميين، كمصر في ظل الرئيس العلماني القومي "جمال عبدالناصر" أو إيران الإسلامية بعد عام 1979.
وقد استخدمت طهران بالمثل الأيديولوجية الشيعية لتصوير نفسها في جميع أنحاء العالم الإسلامي كقوة إسلامية معادية للإمبريالية.
ومنذ الثورات العربية عام 2011، برزت القوة الإسلامية الناعمة كجزء متزايد الأهمية في الجغرافيا السياسية الجديدة للدين، وبشكل أكبر من الماضي، تحاول الحكومات الإسلامية اليوم صياغة الخطاب الديني والتحكم في المعرفة الدينية من أجل تحقيق مصالحها الوطنية.
لنأخذ مثالا اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي" في أكتوبر/تشرين الأول من قبل عملاء سعوديين في إسطنبول، الأمر الذي مثل مشهدا غريبا لنظام إسلامي متشدد يقتل كاتبًا متهمًا إياه بأنه إسلامي.
وتعارض المملكة العربية السعودية نوعًا معينًا من الإسلاموية، أي "الإخوان المسلمون"، ومع ذلك، كانت المملكة العربية السعودية، قبل عشرات السنين، سعيدة للغاية بتوفير الملاذ الآمن وفرص العمل لأعضاء جماعة "الإخوان المسلمون"، مع الاستعانة بالجهاز التبشيري الهائل لفروع الحركة الإسلامية.
وحصلت شخصيات "الإخوان" المنفية على مناصب في كليات في الجامعات السعودية، وكثيرون منهم كانوا يعملون في المستويات العليا من المنظمات الدينية الدولية التي تمولها المملكة العربية السعودية، مثل رابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية للشباب الإسلامي.
لكن بعد ثورات عام 2011، عندما فازت الأحزاب السياسية المرتبطة بـ"الإخوان" في الانتخابات في مصر وتونس، أصبحت العائلات المالكة في الخليج ترى الحركة بمثابة تهديد وجودي لبقائها.
تحول المواقف
تصف مصر والسعودية والإمارات الآن جماعة "الإخوان المسلمون" بأنها منظمة إرهابية، خوفًا من أن مزيج الجماعة من القوة الدينية والمهارات التنظيمية سيسمح لها بالتواصل مع شعوبها.
ومع ذلك، فإن أعداء الإسلاميين على الأرجح - مثلهم مثل الإسلاميين - يخلطون بين الدين والسياسة، فقط مع اختلاف الطريقة.
تحاول الحكومات المناهضة لـ"الإخوان المسلمون" بقوة فرض سيطرتها على المؤسسات الدينية وتعزيز ما يمكن تسميته "الإسلام الرسمي"، وهو نسخة من الدين خاضعة لمصالح الدولة.
في مصر، يدعو الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الأزهر إلى تحديث منهجه تجاه مصادر التشريع الإسلامية كجزء من "ثورة دينية" أوسع نطاقاً يمكن أن تقابل الإسلام المعارض للإخوان المسلمين والإسلام العنيف لتنظيم الدولة والقاعدة.
وتعهد ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" في عام 2017 بإعادة المملكة العربية السعودية إلى "الإسلام المعتدل" الذي زعم أنه كان منتشرًا في المملكة.
وقد قام "بن سلمان" بتقليص نفوذ الشرطة الدينية في المملكة العربية السعودية، وأزال سلطاتهم للقيام بالاعتقالات، وأصدر أحكاما قاسية ضد شخصيات دينية مستقلة مثل الشيخ "سلمان العودة"، وهو رجل دين يتمتع بشعبية كبيرة له علاقة سابقة مع "الإخوان المسلمون".
وفي حين أن الملوك السعوديين السابقين وكبار العائلة المالكة قد سمحوا على الأقل بنفوذ الإسلام والمؤسسات الدينية في البلاد، فقد أوضح "بن سلمان" أن الإسلام المعتدل بالنسبة له لا يتعلق فقط برفض تنظيم الدولة وإنما بالترويج للاحترام للسلطات السياسية القائمة.
كما طوّرت القوتان الخليجيتان الأخريان، قطر والإمارات، طرقا لدعم الدين في الخارج.
ووضعت قطر نفسها كراعٍ للإسلام السياسي على غرار جماعة "الإخوان المسلمون"، ما أجج إلى حد كبير استياء الرياض وأبوظبي وفي غضون ذلك، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة بهدوء في العقد الماضي كراع لعدد من كبار علماء الصوفية، كما قامت بتمويل مؤتمرات رفيعة المستوى تجمع ليس فقط قادة مسلمين من جميع أنحاء إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، لكن قادة مسيحيين وقادة يهود من أوروبا والولايات المتحدة أيضا.
وأحد المواضيع الرئيسية لهذه المؤتمرات هو التعددية الدينية، لكنها تعددية هادئة لا تتحدى الدولة.
الإسلام والنظام الليبرالي
بالنسبة للولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، فإن واقع القوة الناعمة الإسلامية يعقد محاولات لفهم الدول المسلمة.
يجب على واشنطن أولاً أن تعترف بأن التنافس الداخلي حول دور الإسلام لا يمكن احتواؤه ضمن حدود البلاد الداخلية وأن السياسات الخارجية للحلفاء السلطويين لا يمكن عزلها عن الصراعات الداخلية في الإسلام ذاته.
وهذا يعني أنه حتى بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين الذين لا يهتمون بحقوق الإنسان، لا تزال هناك أسباب مهمة - على طول خطوط "المصالح الوطنية" - لإيلاء اهتمام وثيق لكيفية قمع الأنظمة لخصومهم المحليين، فلا يمكن أن تصبح انتهاكات حقوق الإنسان مجرد مسألة للمثاليين السذج الذين لا يدركون الحقائق الصعبة للسياسة الواقعية.
وقد اكتسبت إدارات مختلفة في الولايات المتحدة، جمهورية وديمقراطية على حد سواء، بعض العادات السيئة عندما يتعلق الأمر بالفاعلين الدينيين الذين يروج لهم كحلول للتطرف الديني.
وكما هو الحال في الإمارات، فإن الأردن والمغرب قد وضعا نفسيهما أيضا كأبطال "للإسلام المعتدل"، وهو الترياق المضاد للتطرف الديني.
وتشيد الحكومات الغربية بجهود هذه الدول للتواصل بين الأديان وإنشاء مراكز تدريب للقادة الدينيين، لكن المؤسسات الدينية في هذه الدول غالباً ما ينظر إليها من قبل السكان في المنطقة كأبواق للحكومات وأصوات لا يمكن الوثوق بها.
لكن كسب القلوب والعقول ليس بالضرورة هو الهدف من هذه الجهود، إن استخدام القوة الناعمة الإسلامية يهدف إلى خدمة الحكومات أكثر مما يخدم الجماهير الإسلامية.
وبدون استثناء تقريباً اليوم، احتضن أولئك الذين يتنافسون على الهيمنة في الشرق الأوسط أشكالاً مختلفة من التوعية الدينية في استراتيجياتهم الإقليمية.
على سبيل المثال، أدى جنون المملكة العربية السعودية بالنفوذ الإيراني في المنطقة إلى تشجيع الرياض، أو على الأقل تغاضيها، عن المشاعر العنيفة ضد الشيعة في بعض الأحيان من الدعاة السعوديين والموالين للرياض خاصة في دول مثل لبنان والعراق، حيث تتمتع طهران بحضور قوي.
وفي حين ينخرط رجال الدين في إدانة كاملة لما يعتبرونه "بدعا" من وجهة نظرهم، فإن تعبيراتهم عن الإيمان تخدم أجندة الدولة السعودية التي تنظر إلى المذهب الشيعي على أنه تجسيد أيديولوجي للنفوذ الإيراني.
وقد سعت إيران، من جانبها، إلى إثارة التوترات الطائفية في دول مثل البحرين والعراق ولبنان، حيث يعاني السكان الشيعة من التمييز والحرمان من الحقوق.
وعلى النقيض من السعودية، لا تستطيع إيران تحمل الانخراط في التحريض المباشر ضد السنة، والذي من شأنه أن ينفر الغالبية العظمى من المسلمين.
بدلاً من ذلك، تستدعي طهران صور الاضطهاد الشيعي من التاريخ الإسلامي في محاولة لمساواة الأنظمة السنية الحالية مع مرتكبي جرائم ضد الشيعة في الماضي.
في كل من هذه الأمثلة، تتشابك الجغرافيا السياسية والإسلام بشكل لا ينفصم، لدرجة أنه من الصعب معرفة أين ينتهي أحدهما وأين يبدأ الآخر.
على الرغم من أن الإسلام كان دائماً حاضراً في السياسة في المنطقة، إلا أن أهميته قد نمت في السنوات الأخيرة، ليس فقط بسبب تداعيات الربيع العربي ولكن أيضا بسبب القرارات التي اتخذت في واشنطن.
حاول الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مثل سلفه، "باراك أوباما"، النأي بنفسه عن التفاصيل المرهقة لسياسة الشرق الأوسط وتسليم المزيد من المسؤولية إلى الحلفاء العرب.
وقد شجع هذا الحلفاء ولاسيما المملكة العربية السعودية على تبني سياسات خارجية أكثر عدوانية، والتي تتطلب بدورها لغة إيديولوجية لاستدامة هذا العدوان.
وتلعب القوة الناعمة الإسلامية، سواء في شكل مناهضة للشيعة أو "الإسلام المعتدل" ، الدور المطلوب تماما.
على نطاق أوسع، هكنا تحول كبير يحدث في جميع أنحاء العالم مع تزايد الشكوك حول مستقبل الليبرالية والنظام الليبرالي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.
ومع تضاؤل الإجماع العالمي حول الليبرالية، فإن المزيد من المساحات تنفتح على الاشتباك الأيديولوجي الأيديولوجي.
وإذا استمرت الولايات المتحدة في الانسحاب من دورها في تعزيز نظام عالمي قابل للتنبؤ، فإن التنافس حول الإسلام - الذي يمكن حشده من أجل أهداف خاصة - من المرجح أن يتكثف.